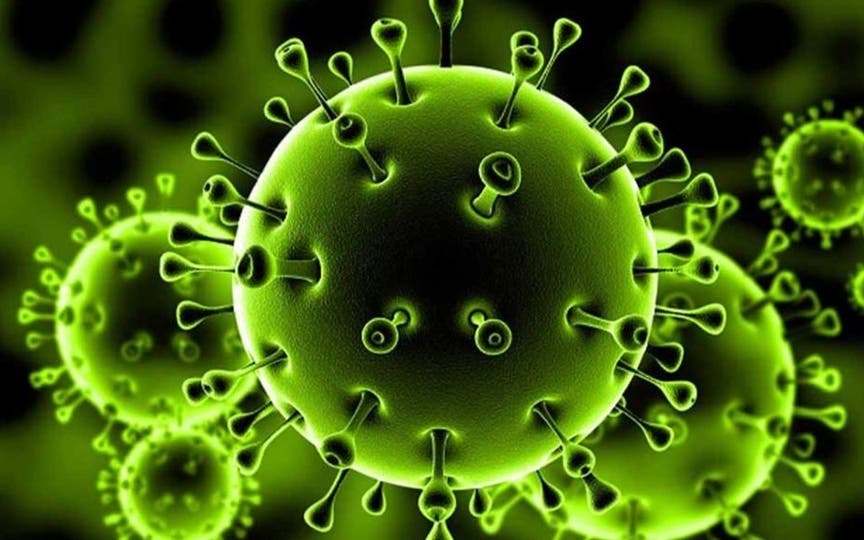
ما بعد كورونا… من أجل الإنسان والوطن”
بقلم حمزة الشافعي
تقديم:
يعود ظهور فيروس كورونا المستجد (2019-(nCoV إلى شهر دجنبر 2019 في إحدى أسواق المأكولات البحرية والحيوانية بمدينة ووهان الصينية، قبل أن ينتشر محليا فإقليميا ثم عالميا، حيث اجتاح بشكل مهول آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وإفريقيا، ليتم تصنيفه من طرف منظمة الصحة العالمية بالجائحة بتاريخ 11 مارس 2020. ولا يزال المصدر الأصلي لهذا الفيروس المستجد مجهولا، ويظل الاعتقاد السائد هو أنه حيواني المصدر، لكن دون إثبات علمي لذلك، علاوة على ذلك، ولكونه فيروسا مستجدا (n=novel)، فلا يوجد أي علاج محدد له، إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
الشهور القليلة المقبلة قد تكشف معطيات جديدة يصعب التكهن بها بخصوص هذا الفيروس المستجد الذي أربك الحسابات الاقتصادية والسياسية والخدماتية لمعظم دول العالم، كما لامس جوانب أخرى متعددة لشعوب تلك الدول (نفسية، اجتماعية، روحية-وجودية، معيشية-اقتصادية، تربوية، فكرية، صحية). فسرعة تفشي الفيروس المستجد وكيفية انتقاله ومصدره الأصلي المجهول وغياب علاج محدد له وانعدام مؤشرات مضبوطة بخصوص مدة زواله وامكانيات تجدده أو تطوره في أي لحظة… كلها أسئلة وهواجس تؤرق بال حكومات الدول وشعوبها سواء التي عرفت تفشيا مهولا أو خفيفا نسبيا، أو تلك التي تعيش الترقب دون أن يصلها بعد، ما دفع بها إلى أخذ جميع الاحتياطات الممكنة كإغلاق الحدود، تعطيل عجلة التبادل الاقتصادي، إعلان حالة الطوارئ، تبني خطة محاصرة بؤر الوباء عن طريق الحجر الصحي، وتعبئة كافة الموارد البشرية والمادية واللوجستيكية والإعلامية والتواصلية للتنبيه إلى خطورة تفشي هذا الفيروس المستجد ومحاصرة بؤره وعلاج ضحاياه.
ويعتبر المغرب ضمن الدول التي تفطنت إلى خطورة انتشار هذا الفيروس، حيث سارع وبشكل ملفت وشجاع إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع توغل هذا الوافد المدمر الذي لا يميز بين صغير أو كبير، أو بين فقير أو غني، خاصة إذا علمنا أن دولا نموذجية في خدمات القطاع الصحي مثل إيطاليا عجزت عن احتواء الوضع الخطير، فما بالك بدول ذات منظومات صحية مهترئة ومحدودة الامكانيات (المغرب كمثال)، نتيجة عدم اعطاءها الأولوية ضمن مخططاتها التنموية وبرامجها الاجتماعية. ومن بين الإجراءات التي اتخذها المغرب لاحتواء الوضع الخطير: توقيف الدراسة بالمدارس والكليات والمعاهد إلى إشعار آخر، تطبيق الحجر الصحي وإعلان حالة الطوارئ، تقييد حركية التنقل بين المدن، تخصيص صندوق لمواجهة تداعيات الجائحة …
قد يكون التفكير في مرحلة “ما بعد كورونا ” Condition/ Post-Corona فعلا سابقا لأوانه، مادام العالم ومعه مستقبل البشرية الآن مفتوح على جميع الاحتمالات في ظل غياب علاج نهائي للفيروس، ودخول بعض الدول المتقدمة في حالة شبه استسلام أمام نتائجه وتداعياته الصحية والاجتماعية والنفسية والمادية والاقتصادية. إلا أنه من باب ملاحظة وتأمل “الواقع الجديد” الذي أفرزته “مرحلة كورونا”، وما فرضه من تحديات على جميع الأصعدة، والاختلالات والنقائص في آليات وبنيات ومنهجيات وذهنيات استقبال واحتواء هذا الواقع الجديد، وهي اختلالات ونقائص لها طبعا امتدادات عضوية مباشرة مع “مرحلة ما قبل كورونا” كغياب الوعي/الثقافة الصحي(ة) لدى الأفراد، الجهل الممؤسس/المدقع/المركب، الفقر والهشاشة، قدرات/مؤسسات/خدمات صحية/استشفائية محدودة، ودون أن نغفل المؤشرات الإيجابية كالتضامن بين مكونات الشعب والتزام نسبة مهمة من الناس بالتدابير المتخذة، فمن المشروع التفكير في المرحلة القادمة (“ما بعد كورونا” ( في إطار الاستعداد والاستباق وطرح البدائل لمستقبل يتوخى منه تجاوز تعثرات ونقائص الحاضر مع تزكية إيجابياته أيضا… مستقبل من أجل الإنسان والوطن ! فكيف يمكن لمجال للتربية والتعليم ومجال الصحة، كمدخلين أساسين ومصيريين في حياة الشعوب والأوطان، المساهمة في تحقيق ذلك؟
مدخل التربية والتعليم:
لا يمكن الحديث عن نهضة وإقلاع أي بلد دون الاستثمار في مجالي التربية التعليم. بيد أن واقع الحال في المغرب إلى حدود فترة كورونا لا ينسجم مع الطرح السالف. فإذا كانت الأنظمة التعليمية العالمية الرائدة والمتفوقة تحفز وتعطي قيمة كبيرة للموارد البشرية العاملة في التربية والتعليم، فإن الهشاشة الاجتماعية والمادية وغياب أبسط وسائل العمل الضرورية بالموازاة مع ظروف عمل مثبطة هي السمات المميزة لرجال ونساء التعليم المغربيين العاملين بالميدان، خاصة في ظل تنزيل وتطبيق نظام التعاقد غير المتوافق عليه، في المدارس العمومية. كما أن وجود نوعين من التعليم، “عمومي” و”خصوصي”، يزيد الهوة بين الطبقات الشعبية/المعدومة الإمكانات، والتي تمثل الأغلبية، والطبقات الغنية/الميسورة كأقلية، ويكرس الفوارق الطبقية بين أبناء البلد الواحد، سواء في طرق التربية وكيفية التعلم أو في إمكانات/آفاق ولوج سوق الشغل.
لا مراء أن المتعلم(ة) المغربي ليس أفضلا حالا من الموارد البشرية التي تسهر على تدرسيه وتأطيره وتكوينه. فهو/هي أيضا ضحية لهشاشة متعددة الأبعاد، مما يؤثر سلبا على الأداء والمردودية الدراسيين، مما يجعل المجتمع والوطن ككل في أزمة حقيقية تتعلق بهدر مواردها الفكرية والمعرفية والعملية والإنسانية/القيمية/الرمزية المستقبلية على المدى القريب والمتوسط والبعيد. من تجليات الهشاشة لدى المتعلم(ة)، غياب الجاذبية في أغلب المدارس نظرا لغياب شروطها كاستقرار زمن التعلم (إضرابات، توقفات، طوارئ الخ)، الحياة المدرسية النشيطة، طرق التدريس الحديثة، الوسائل التكنولوجية والمختبرات العلمية، الإطعام المدرسي، النقل المدرسي في المناطق النائية، المكتبات والخزانات المجهزة، دور الأسرة والإعلام في التربية، الاكتظاظ والبنية التقليدية للفصول والفضاءات، تحفيز ومواكبة الأطر التربوية والإدارية، الرغبة في الاستثمار في أطفال المدرسة، عوامل متعلقة بالفقر والطبقية، التجديد في المناهج والمقررات التربوية، الاستثمار القيمي-الإنساني والإبداعي-الابتكاري في الأطفال واعتبارهم مجرد مشاريع مهنية-تقنية مستقبلية (سبب/جوهر وجود الأطفال في المدرسة = الإعداد/التكوين التقني للشغل/المهن)…
ومن ضمن الدروس التي يعطيها “راهن/حاضر كورونا” والتي ينبغي الاستفادة منها من أجل الإنسان بشكل عام ومن أجل نهضة الوطن بشكل خاص، واستعدادا لدخول وخوض مرحلة/تجربة “ما بعد كورونا” بثبات ويقين في الانتصار ما يلي:
القطع مع ثنائية “تعليم عمومي” و “تعليم خصوصي”، والاقتصار على نمط تعليم عمومي مجاني مفتوح في وجه جميع أبناء الوطن؛ تعليم يضمن لكافة أطفال وطلبة المغرب تعليما جيدا وفق شروط ومعايير موحدة، لأن التمدرس الجيد لكل أطفال وطلبة المغرب استثمار واعد في طاقاته البشرية، ورهان إقلاعه في فترات الاستقرار وصمام أمانه وتماسكه في الأزمات (الجائحات والأوبئة المحتملة ما بعد كورونا مثلا).
إيلاء الأهمية القصوى لتكوين أطر التربية والتعليم وفق مستجدات العصر التربوية، والعمل على إنصافهم رمزيا وماديا واجتماعيا إذ لا يعقل أن المفترض فيهم أن يكونوا قدوة المجتمع الأولى يعانو من الهشاشة المادية والرمزية والتكوينية والاجتماعية، نتيجة عدم القدرة المالية على مسايرة متطلبات الحياة، حتى البسيطة منها (سكن، نقل شخصي، موارد البحث الأكاديمي …).
الاهتمام بكل أطفال المدارس على جميع الأصعدة (نفسية-سلوكية، وجدانية-روحية، اجتماعية-قيمية، دراسية-معرفية، بدنية-ترفيهية، صحية-غذائية…)، ودون تمييز على أساس جغرافي أو طبقي أو ثقافي أو لغوي.
إدراج مادة “التربية الصحية” ضمن المواد المدرسة منذ المراحل الأولى، حيث يتكلف بها أطر مكونة في المجال الصحي والنفسي لبناء وتكوين أجيال لها وعي صحي وتوازن شخصي/نفسي، كمادة متكاملة مع المواد الدراسية الأخرى كالتربية البدنية واللغات والعلوم التجريبية والعلوم الإنسانية والتكنولوجيا والإعلاميات…
التركيز على الجوانب النفسية والاجتماعية والقيمية-الأخلاقية والصحية والإبداعية في المدرسة في تكامل مع أدوار الأسرة، بدل الاقتصار على تلقين وشحن المتعلم(ة) بالمعارف والدروس النظرية…
التعامل مع كل طفل كذات إنسانية حاملة لقيم إنسانية سامية وكمشروع علمي وفكري-إبداعي قادر على الإنتاج والابتكار في المستقبل، وتسخير جميع الطاقات البشرية والمادية واللوجيستيكية في بناءه وتكوينه ومواكبته، والاستثمار في جميع الموارد البشرية على المدى المتوسط والبعيد، والقطع مع الهدر البشع للموارد والطاقات البشرية، لأن نهضة وتقدم المجتمعات والأوطان تحددها درجة بناء والنجاح في الاستثمار في أفراده.
الارتكاز على مخططات تربوية-تعليمية عميقة ذات بعد إنساني-علمي-إبداعي وبعيدة الأمد محورها بناء/تأطير أطفال الوطن، بدل نهج سياسات تربوية متذبذبة ومتغيرة وضبابية غير مدروسة النتائج على أبعد مدى.
تجهيز جميع المدارس في جميع ربوع المملكة بفضاءات الدراسة الملائمة واللعب والترفيه والإطعام والوسائل التكنولوجية الحديثة والمختبرات العلمية والنقل المدرسي دون تمييز بين الجهات والمجالات الجغرافية والطبقات الاجتماعية.
مدخل الصحة:
إلى جانب التربية والتعليم، يعد الميدان الصحي إحدى المداخيل التي يجب عدم التماطل لأي سبب من الأسباب في تأهيليها وإصلاحها، لأنه مجال مرتبط بشكل كبير بحماية/وقاية وتثقيف/توعية وإنقاذ حياة/علاج الأفراد، سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، إلا أن الواقع الصحي المغربي الحالي تلازمه سمة الهشاشة من حيث البنيات والخدمات الاستشفائية. ويكفي لإنسان ينتمي مثلا إلى مدينة مثل تنغير بالجنوب الشرقي أن يمرض، ليجد نفسه مضطرا للتنقل بين مدن بعيدة كفاس ومكناس ومراكش والرباط وفي متاهات مصحات تجارية لا ترحم الفارين إليها، لغياب مستشفيات عمومية مجهزة في مدن الجنوب الشرقي المغربي. ولتجاوز الوضع الصحي المؤلم الذي لن تكفي عشرات المقال في رصد معاناة المرضى والأصحاء على حد السواء وهم يسردون تجاربهم التراجيدية الشبه يومية، يجب الانكباب على القيام بما يلي:
اعتماد مبدأ تحفيز وتشجيع الموارد البشرية؛ وذلك بجعل أطر الصحة بجميع أصنافهم إلى جانب أطر التربية ضمن أعلى الهرم الأجري والرمزي والاجتماعي نظرا لأدوارهم الحيوية في الظروف العادية، ولحاجة الوطن إلى خدماتهم وتضحياتهم وقت الأزمات والطوارئ، وإعطاءهم القيمة التي يستحقونها لتحفيزهم على المزيد من البذل والعطاء والبحث والابتكار، وتخليصهم من ضغوطات جانبية تؤثر سلبا على مردوديتهم المهنية والفكرية والعلمية (عدم القدرة على مسايرة غلاء الأسعار، عدم القدرة على تملك سكن، ظروف اشتغال مزرية، عدم قدرتهم على مصاريف التكوين الأكاديمي المستمر الخ).
القطيعة مع ثنائية “عمومي” و “خصوصي” في مجال الصحة، ووضع نظام صحي وطني واحد يسمح لجميع المواطنين بالاستشفاء والاستفادة من الحق في الرعاية الصحة كأحد الحقوق الإنسانية الكونية دون تمييز أو أداء أو تأجيل أو تهميش.
الاستثمار في القطاع الصحي العمومي و”عدم رفع اليد عنه” عن طريق تكوين أكبر عدد ممكن من الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة وفي جميع التخصصات، لحاجة المواطن لخدماتهم بشكل يومي في الظروف العادية، ولحاجة الوطن لهم في الأزمات، خاصة أن العالم منفتح على حروب ومواجهات تضع تداعياتها المنظومة الصحية على المحك (نموذج إيطاليا التي انهكها فيروس كورونا رغم قوة وتطور نظامها الصحي وكونه ضمن الأنظمة الأوروبية الرائدة).
توجيه أكبر عدد ممكن من المتعلمين والمتعلمات نحو التكوينات الطبية والتمريضية والشبه طبية، مع إنشاء كليات للطب ومعاهد للمهن التمريضية وتقنيات الصحية في كل مدينة دون تمييز مجالي ودون استثناء أي منها من هذه المؤسسات الحيوية.
اعتماد مبدأ العدالة الصحية بين كل المناطق وبناء مستشفى خاص بكل تجمع سكاني وفق شروط جيدة وموارد بشرية متخصصة ومتعددة، والقطيعة مع مبدأ التهميش وحرمان مناطق بعينها من الخدمات الصحية (مدن الهامش كتنغير) دون مراعاة البعد الجغرافي لها عن مدن المركز وفقر ساكنتها ووعورة طبيعتها.
إيلاء البحث العلمي مكانة عظمى عن طريق بناء وتنويع مراكز البحث والمختبرات في المجال الطبي والبيولوجي في كل ربوع المملكة وتشجيع الباحثين والخبراء على البحث العلمي المستدام.
بناء “مدن صحية” احتياطية وتجهيزها في كل جهة تضمن الحجر الصحي بشروط أكثر أمنا، تحسبا لأي جائحة مرتقبة أو حرب جرثومية/بيولوجية محتملة في ظل (اختلال) التوازنات والتحولات والصراعات الي يشهدها العالم.
نشر الوعي الغذائي الصحي والممارسات الاستهلاكية الوقائية بخصوص نوع الأطعمة والمشروبات التي يجب على المواطن استهلاكها، سواء عن طريق المدارس أومن خلال حملات يومية مباشرة وإعلامية وبرامج تثقيفية، والمراقبة الصارمة للمواد الغذائية المقدمة للمواطن من طرف شركات الإنتاج والأسواق التجارية لتفادي الأخطار الناجمة عن المواد المعروضة كالتسممات والأمراض …
خاتمة:
طالما تمنى كل فرد أن يرى وطنه أولا، ينعم بالأمن والاستقرار والرفاهية في الظروف العادية، وثانيا، قويا قادرا على مجابهة التحديات والطوارئ التي تفرضها الأخطار المتعددة والأوبئة المستجدة كفيروس كورونا. لكن، وفي دول العالم الثالث التي لم تستفد/تستفق أبدا من الصدمة التي خلفها الاستعمار (الصدمة الاستعمارية Colonial Shock/Trauma)، فالهشاشة في المجالات الحيوية كالتعليم والصحة هي السائدة، نتيجة سياسات ومخططات متبعة على مدى عقود تحت تأثير الصدمة (الاستعمارية)، لتفتح الباب على مصراعيه ل”صدمة مزدوجة” بظهور جائحات/أوبئة طبيعية أو تجدد استعمار باستراتيجيات وأهداف وأنماط غزو-مقاومة مغايرة، كما هو الشأن لفيروس كورونا المستجد. ولكون الإنسان والوطن لا يستحقان أبدا أن يلدغا في جحرهما مرتين، كان لزاما على الجميع تحمل المسؤولية التاريخية المشتركة في صون وحماية الحاضر(الحياة)، واستشراف المستقبل بنفس تحرري (الحياة-الوقاية-المناعة-الأمان) بآليات وإجراءات ناجعة روحها التربية واليقظة والوطنية والانتماء والتضحية والوفاء، بدل “رفع اليد عن التعليم والصحة”، واللهث وراء الثراء الفاحش عن طريق خوصصة ما يمكن خوصصته، في انتظار الخوصصة الشاملة (حتى للأكسجين)، ومن ثم ترك الإنسان والوطن فريسة سهلة للأوبئة والفيروسات والجائحات واللاقيم وفقدان الحق في الحياة….
من حقنا أن نحلم كثيرا… أحلاما جميلة… فإن تحققت، تزين الوطن وصار جميلا واحتفل. وإن لم تتحقق، قلنا لأحلامنا أننا عرفنا بك بين أبناء الوطن.











